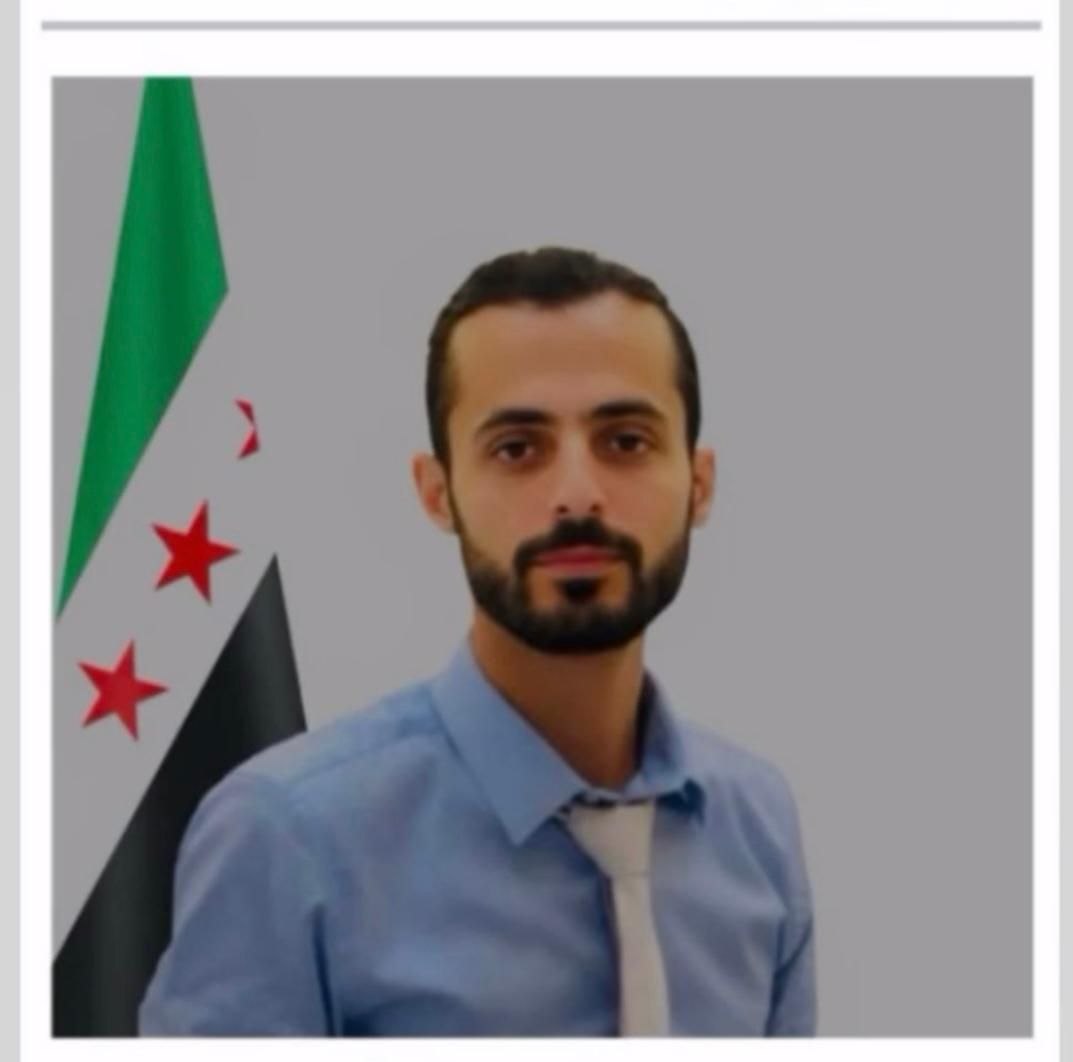الوحدة – حسين علي ملحم – باريس
شهدت مدن الساحل السوري هذا الثلاثاء، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، خروج احتجاجات سلميّة عبّرت عن مطالب مدنية ومعيشية وسياسيّة، في مشهد يُعيد رسم ملامح العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويكشف عن تحوّل لافت في الوعي السوري العام. فالمناطق التي لطالما ارتبطت بصورة نمطيّة عن الانغلاق السياسي والقمع الفكري بسبب هيمنة عائلة الأسد وشبّيحتهم عليها، خرج أبناؤها اليوم ليؤكّدوا أن حرية الرأي ليست امتيازًا يرتبط بجغرافيا فحسب، بل هي حقٌّ إنسانيٌّ أصيلٌ يُولد مع الإنسان أينما كان.
وقد بدا لافتًا أن الحركة اليوميّة عادت سريعًا إلى حالتها الطبيعيّة بعد خروج تلك الاحتجاجات ومظاهرات التعبير عن الرأي، وأنّ قوى الأمن العام تحرّكت لتأمين الحماية للمتظاهرين وتنظيم حركة المرور والشوارع وضمان سلامة التجمّعات. هذا السلوك الذي يحترم قواعد الاحتجاج السلمي، يفتح بابًا لتحليلٍ أعمق لمفهوم السلطة في السياق السوريّ، إذ إنّ شرعيّة الدولة في الفكر السياسي الحديث تقوم على قدرتها على صون حقوق المواطنين قبل فرض الواجبات عليهم، ويغدو الاستماع لمطالب الناس جزءًا من وظيفة الدولة، لا خروجًا عليها.
ولعلّ ما يجعل هذه التحرّكات ذات دلالةٍ هو أنّها تأتي في منطقة لطالما صُوِّرت على أنّها بعيدةٌ عن المجال الاحتجاجي. غير أنّ خروج المتظاهرين في طرطوس و حمص واللاذقية يؤكّد أنّ التطلّع إلى الحرية لا يُختزل في منطقة دون أخرى، وأنّ الصمت الذي ساد طويلًا لم يكن حالةً اختياريّةً بقدر ما كان نتاجًا لعوامل ديكتاتورية وقمعية معقّدة في عهد الأسدين ونظامهما الساقط. ما حدث يُثبت أنّ الاحتجاج فعلٌ إنسانيٌّ قبل أن يكون سياسيًّا، وأنّ رغبة الشعب السوري في قول رأيه والسعيِ لكرامته تتجاوز كل التصنيفات والهويّات المسبقة.
والواقع أنّ القدرة على رفع الصوت اليوم لا يمكن فصلُها عن الإرث الذي تركتْه الثورة السوريّة منذ عام 2011، حين ملأ أبناء البلاد الساحات مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة. وقد أثبتت تلك اللحظة التاريخيّة أن حقوق الناس لا تُمنح من فوق، بل تُنتزع بتضحياتهم، وهذا كلّه بفضل مبادئِ وأخلاق أبناء الثورة الذين آمنوا بحرّيّة التظاهر وملؤوا الساحات العامّة منذ 2011، وبفضل الثورة العظيمة ذاتها التي قدّم شعبُنا الحرُّ من أجلها تضحيات مباركة دفاعًا عن كرامة الإنسان مهما كان عرقُه أو مذهبُه. إنّنا اليوم نمارس حقًّا انتُزِع بتضحيات جسيمة، ونتمسّك به حفاظًا على ما بذله أبناء الوطن من دمائهم كي يعيش الجميع أحرارًا بلا خوف ولا تمييز. هذه الكلمات ليست مجرّد استدعاء للماضي، بل وصفًا دقيقًا لواقعٍ يتأكّد اليوم، حيث تتحوّل مبادئُ الثورة إلى وعي عام يتجاوز حدود الانتماءات ويعيد للإنسان مكانته في المجال العام.
وإذا كان انتشار دوريات جهازِ الأمن العام لحماية المحتجّين قد أثار اهتمام مراقبين كثر، فلأنّ هذا السلوك يعكس حقيقةً مركزيّةً في الفلسفة السياسيّة: السلميّة لا تُهدّد الأمن، بل تعزّزُه. حين تُعامل الدولة مواطنيها كأصحابِ حقٍّ لا كخصومٍ، فإنّها تُسهِم في تخفيف الاحتقان وإعادة بناء الثقة. كما أنّ التأكيد الرسمي على الاستماع إلى المطالب يعكس إدراكًا متزايدًا لأهميّة فتح مساحات حقيقيّة للتواصل بين الدولة والمجتمع. وفي سياق معقّد كالواقع السوري، تصبح كل لحظة يُتاح فيها المجال للتعبير السلمي فرصة لمراجعة العلاقة بين السلطة والشعب، ولتجاوز التحدّياتِ التي أرهقت البلاد لسنواتٍ طويلة.
إنّ الاحتجاجات التي شهدها الساحل السوري لا تعبّر عن انقلابٍ في موازين القوى ولا عن تفكّكٍ اجتماعيٍّ، بل عن عودةٍ طبيعيّةٍ لصوت الإنسانِ الذي يسعى لأن يُسمَع. وإذا كان السوريّون قد عاشوا زمنًا طويلًا تحت وطأةِ الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة ، فإنّ الاحتجاج السلمي المحمي يُمثّل خطوةً ضروريّةً نحو إعادة الاعتبار للفضاء العام، وإعادة تعريف دور الدولة بوصفها ضامنًا للحقوق لا مجرّد قوّة ضابطة. ما يحدث اليوم، على محدوديّته، يشير إلى أنّ الوعي السوري لم ينطفئ، وأنّ حرية التعبير عن الرأي لن يخمد صوتها لا في الساحاتِ ولا في الحناجر. وربما لا تُغيّر احتجاجات الساحل وحدها واقعًا شديد التعقيد، لكنّها تكشف أنّ السوريّين لا يزالون قادرين على المطالبة بحقوقهم، ومبادئ ثورتهم قائمة في ضمائرهم وكما أن التظاهر السلمي و التعبير عن الرأي حق دستوري للشعوب فإن الحفاظ على سلامة المظاهرات و أمن المتظاهرين هو من واجبات اجهزة الدولة المؤسساتية.